تحول المجال السوداني إلى حيز اختبار لتفوق المسيرات
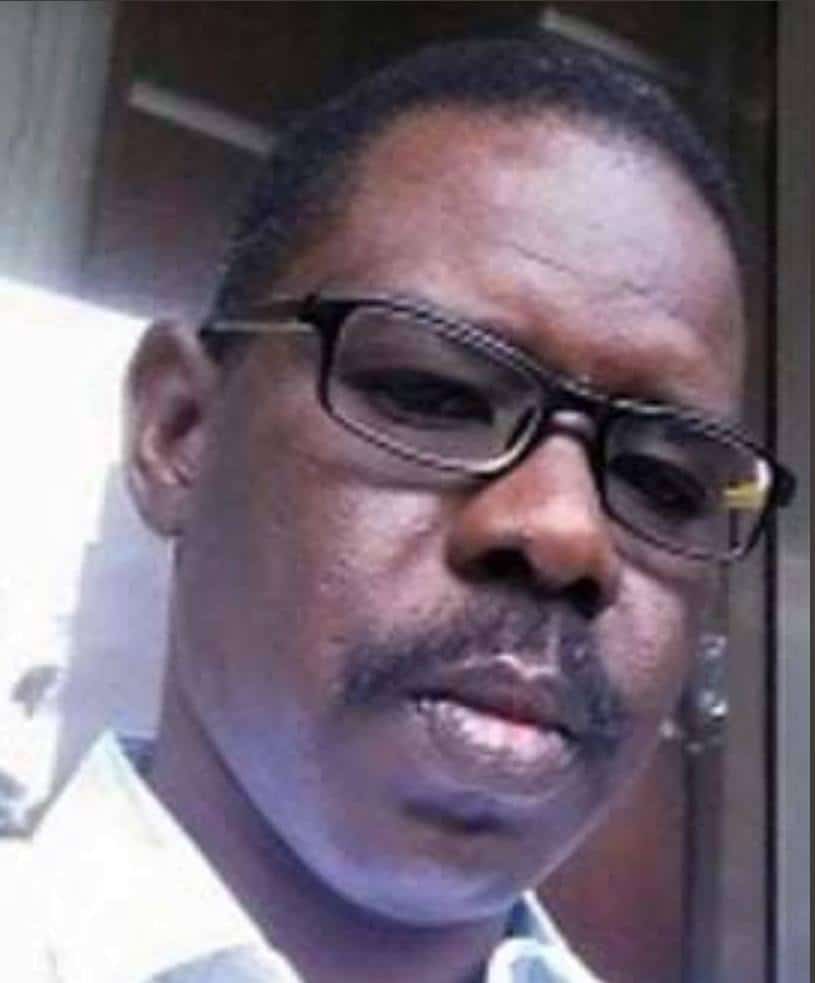
بقلم: محمد بدوي
شهد السودان في مطلع الشهر الأول من مايو ٢٠٢٥، الذي يصادف بداية السنة الثالثة للحرب الدائرة فيه بين الجيش والدعم السريع وتحالفاتهما المقاتلة التي برزت مع استمرار الصراع، أحداثًا مفصلية. تمثلت هذه الأحداث في قصف الجيش لطائرة شحن من طراز “بوينغ” بمطار نيالا بولاية جنوب دارفور، وهو قصف أُصيب على إثره ما يقارب ٧٩ من مقاتلي الدعم السريع، بمن فيهم قائد الطائرة (الكابتن) الذي تنحدر أصوله، وفقًا لوسائل الإعلام، من دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين من مساعديه الكينيين. بالمقابل، استهدف الدعم السريع عبر المسيّرات مطاري كسلا وبورتسودان، وصهاريج وقود وأعيانًا مدنية أخرى ببورتسودان. وامتد الأمر إلى قصف سد مروي بالولاية الشمالية، والدمازين بالنيل الأزرق، وخزانات نفطية بكوستي، ومواقع بكنانة بولاية النيل الأبيض. مثّلت هذه التطورات نقلة نوعية شرسة ومتسارعة في سياق القتال، حيث برزت أهداف الدعم السريع المتمثلة في قصف المطارات، والمقار العسكرية، ومخازن السلاح، ومحطات تخزين الوقود.
الجدير بالذكر أن دخول المسيّرات في حرب السودان بدأ تقريبًا في أغسطس ٢٠٢٣ من طرف الدعم السريع، بينما تأخر الجيش حتى مارس ٢٠٢٤، وفقًا للمصادر المفتوحة. وهذه ليست معلومات موثوقة تمامًا، فقد يكون امتلاك الأطراف للمسيّرات قد سبق ذلك، لكن الاستخدام الفعلي بدأ في التواريخ المشار إليها.
بالعودة إلى سياق الحرب، كان قائد الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قد أعلن في خطاب له عقب بدء خروج/انسحاب قواته من ولاية الخرطوم، أن الخطوة تهدف إلى “إعادة التموضع العسكري”. لكن الأمر ظل مختلفًا عليه حول أسبابه الحقيقية، كما اتضح من تصريحات الجيش التي ذهبت إلى عكس ذلك، مؤكدةً أن السيطرة على تلك المناطق تمت عسكريًا، وأن الخروج كان إجباريًا، مع الإشارة إلى استمرار تواجد قوات للدعم السريع غربي أمدرمان.
عقب ذلك، كشف الدعم السريع عن إسقاط طائرات عسكرية في كل من الفاشر ونيالا والخرطوم، الأمر الذي عزاه إلى امتلاك أسلحة متطورة تشمل المسيّرات ورادارات التشويش. في ظل هذه السردية، جاء قصف الجيش لطائرة الشحن بمطار نيالا ليكشف عن ثغرات في سردية الدعم السريع المتعلقة بتأمين الفضاء الجوي نسبيًا، ويشير في ذات الوقت إلى امتلاك الجيش أسلحة يُرجح أن من بينها مسيّرات حديثة وتقنيات تمكّنه من اختراق رادارات الدعم السريع.
لعل هذا التطور يكشف عن سرعة تحرك الدعم السريع عبر سلسلة الاستهدافات لعدة مناطق، مما أدخل الإقليم الشرقي إلى دائرة الحرب بعد استقرار دام عامين. وفي سياق متصل، استدعت السلطات السودانية قبل وقت قصير السفير الصيني بالخرطوم للاستفسار منه عن امتلاك الدعم السريع لمسيّرات صينية الصنع، وهو ما قد يفسر التوجيه الذي أصدرته الحكومة الصينية لاحقًا لرعاياها المتواجدين بالسودان بالمغادرة فورًا.
بالمقابل، في ٤ مايو ٢٠٢٥، أي اليوم التالي للاستهداف الأول لمطار بورتسودان الدولي وقاعدة فلامنغو العسكرية، كشفت مصادر صحفية عن هبوط وإقلاع طائرة إسعاف تركية، عملت على إجلاء طاقم فني تركي يُعتقد أن له صلة إشرافية على مسيّرات تركية يمتلكها الجيش، والتي يُرجح أنها كانت وراء قصف مطار نيالا في الأول من مايو ٢٠٢٥.
المعلومات غير الرسمية التي رشحت من الجيش أو الدعم السريع أو وسائل الإعلام المحلية، يمكن تلخيصها لتتبع أسباب هذا التطور العسكري العنيف، في امتلاك الأطراف الرئيسية للحرب لمسيّرات تركية وصينية الصنع. ويُشار إلى تفوق الجيش في اختراق رادارات الدعم السريع (وليس الجيش) بمطار نيالا، وتدمير مخزون من الأسلحة. الأمر الذي قاد إلى سباق من قبل الدعم السريع للقضاء على مخزون الجيش من المسيّرات التركية وغيرها من الأسلحة المتطورة المتواجدة بمطار بورتسودان، واستهداف المستودعات النفطية للتأثير على الحركة اللوجستية للجيش، وإدخال نشاط الحرب إلى قرب ساحل البحر الأحمر. يأتي هذا في وقت كانت قد توقفت فيه الغارات الأمريكية على الحوثيين باليمن على خلفية استهدافهم للسفن التجارية، ولعل تأثير تلك العمليات الحوثية على السفن قد أثّر على عائدات قناة السويس بنسبة كبيرة خلال عام ٢٠٢٤.
عطفًا على ما سبق، فمع بداية العام الثالث للحرب في السودان، صار هناك سباق لامتلاك الأسلحة المتطورة من قبل الأطراف. بالمقابل، تشير هذه الحالة إلى وضعية تفوق للمسيّرات لصالح الدول المصنعة. يمكننا تقصي ذلك في تفوق المسيّرات التركية في اختراق مطار نيالا، وفشل الدفاعات الأرضية في بورتسودان في صد المسيّرات الصينية.
من ناحية ثالثة، ووفقًا لتقرير حقوقي من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن دولة الإمارات أعادت تصدير أسلحة صينية الصنع للدعم السريع. الأمر الذي يعيد الربط بين الإمارات ومحاولاتها السابقة خلال الفترة الانتقالية للاستحواذ على امتياز تشغيل ميناء بورتسودان، ثم التحول إلى التفكير في ميناء آخر بمنطقة أبو عمامة. بالمقابل، فقد ظل وجود تركيا بميناء سواكن في فترة سيطرة النظام السابق وبعض الوقت خلال الفترة الانتقالية، فيما ظلت إسرائيل تسعى لحيز أمني أيضًا على ساحل البحر الأحمر في تلك الفترة التي نشطت فيها محاولات لحمل السلطة الانتقالية آنذاك للتطبيع معها.
جميع هذه النقاط يمكن تلخيصها في سياقين: داخلي وخارجي. فالسياق الداخلي يتمثل في أن الحرب التي بدأت في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ في السودان وصلت مرحلة التنافس في امتلاك التقنيات العسكرية الحديثة، وما حدث في مطاري نيالا وبورتسودان رهنٌ بما ستكشف عنه الأيام القادمة، وبمن سيتمكن من الحصول على تقنيات عسكرية يتفوق بها على الآخر، بما يشمل المسيّرات والرادارات.
أما في السياق الخارجي، فإن الحرب صارت أكثر ارتباطًا بمصالح الحلفاء الإقليميين، والخريطة الجديدة للموارد. حيث لا بد من الوقوف على أن عام ٢٠٢٥ شهد قصفًا لمدينتي بورتسودان والحديدة اليمنية الساحليتين. إضافة إلى الأحداث الموازية التي لا تنفك عن كونها جزءًا من مشهد التنافس حول تقنيات التسليح، مثل التفوق الصيني على مقاتلات الرافال الفرنسية في الصراع الذي بدأ بين الهند وباكستان؛ وهي حالة أثبتت أن وقف القتال ممكنٌ بالوعي والإرادة السياسية.
تحول سماء السودان إلى ساحة اختبار لتقنيات الأسلحة الحديثة لصالح الدول المصنعة يشير إلى اتساع نطاق الأطراف الدولية في حرب السودان. الأمر الذي ينعكس مباشرة على طول أمد الحرب في السودان عبر تحول الحيز والمجال السوداني لساحة اختبار لتفوق الأسلحة لصالح الدول المصنعة. وأن السؤال القادم هو: مَن الحليف الدولي الذي سيظهر في مشهد السيطرة على موانئ بورتسودان والحديدة والساحل؟
الخلاصة: ما يجري في السودان لا بد من النظر إليه في سياقه التاريخي، بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠١٣، وصراعات حزب المؤتمر الوطني المحلول حول انتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٥، واقتناص أطراف من الوطني المحلول للصراع وإعادة تنظيم حرس الحدود ليصبح الدعم السريع في عام ٢٠١٤، وحصول القوات الرديفة بدارفور على ٥٤ مليون دولار في عام ٢٠١٤ من عائدات الذهب بأسواق دبي. كما أن السبب الرئيسي لبدء انسحاب بعثة اليوناميد في عام ٢٠١٧ – عقب التلويح بالقرار في عام ٢٠١٥ إلى اكتماله في عام ٢٠١٩ – مرتبط بتأثير الأزمة المالية العالمية وتغير سياسات بعض الدول الممولة للبعثة مثل الإدارة الأمريكية. ويُضاف إلى ذلك تعاقد الإمارات على ميناء بربرة بأرض الصومال في عام ٢٠١٥ واستئجار مهبط بميناء عصب الإريتري في عام ٢٠١٧، ليمر العالم بأزمة مالية أخرى نتيجة لجائحة كوفيد. مع العلم أن السودان وصل ذروة الأزمة الاقتصادية بدءًا من عام ٢٠١٦ حتى سقوط نظام الحركة الإسلامية في عام ٢٠١٩، ليتم زعزعة الفترة الانتقالية في السودان بعدة طرق من قبل فلول النظام السابق للعودة للسلطة. ثم جاء انقلاب عام ٢٠٢١ الذي مثّل مرحلة ما قبل حرب ٢٠٢٣ الراهنة. لنختم القول بأن التنافس الداخلي والخارجي حول السلطة والموارد هما الدافعان الرئيسيان للحرب، وأن التأخير في وقف الحرب من الأطراف الداخلية قد يقود إلى ضم الحالة السودانية إلى المشهد الدولي الذي ترتبط فيه التسويات بمقابل الموارد، أو احتمال الإخضاع للإشراف الأجنبي أيضًا كطريق للسيطرة.
sudantribune.net